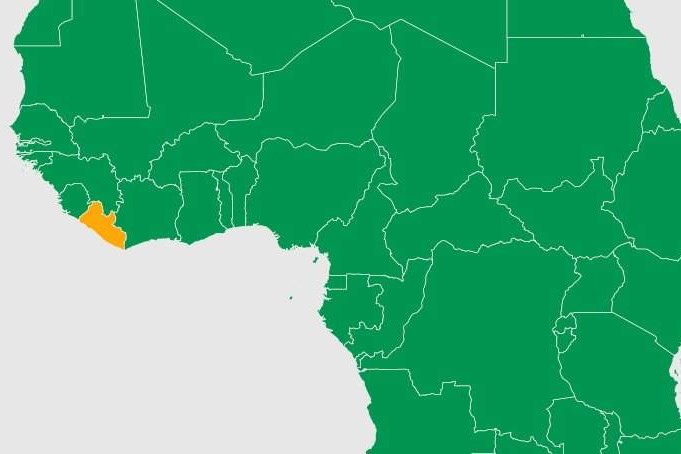مع تنامي شعور القادة الأوروبيين بتراجع الالتزام الأمريكي تجاه القارة، تتجه العواصم الأوروبية تباعاً نحو بكين بحثاً عن بدائل تجارية وأمنية. غير أن هذا الانفتاح المتسارع يثير سؤالاً جوهرياً: هل يعكس رؤية استراتيجية مدروسة، أم مجرد استرضاء قصير النظر لقوة صاعدة؟
في هذا السياق، يخطط المستشار الألماني فريدريش ميرتس لزيارة الصين مطلع العام، على الأرجح في أواخر فبراير، فيما يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لزيارة مماثلة بعد أن قدّمت حكومته تنازلاً سياسياً لبكين بالموافقة على مشروع «السفارة الضخمة». أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقد سبق الجميع بزيارة رسمية إلى العاصمة الصينية مطلع ديسمبر الماضي.
تعكس هذه التحركات تعطشاً أوروبياً واضحاً للصين، في مجالي التجارة والأمن على السواء. غير أن هذا المسار، كما حذّرت مارغريت تاتشر يوماً، «تفوح منه رائحة الاسترضاء». فالقادة الأوروبيون يبدون مستعدين لتقديم التنازلات لبكين، مع قدر محدود من التفكير في التبعات الاستراتيجية بعيدة المدى.
يعود هذا التحول جزئياً إلى التراجع الحاد والمفاجئ في الدعم الأمريكي لأوروبا، كما يصفه مارك ليونارد، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إذ باتت الولايات المتحدة، في نظر كثير من الأوروبيين، شريكاً متقلباً أقرب إلى الخصم منه إلى الحليف.
زاد من هذا القلق تصعيد الرئيس دونالد ترامب، ولا سيما تصريحاته الصريحة حول ضم غرينلاند بالقوة، وهي إقليم تابع للدنمارك، وما رافق ذلك من تهديدات بفرض رسوم جمركية على الأوروبيين إذا عارضوا هذا الطرح. وقد تعاملت أوروبا مع هذه التصريحات بوصفها تهديداً مباشراً، لكنها انشغلت بها على حساب مخاطر أعمق وأبعد مدى.
فالتحدي الأخطر لا يكمن في ترامب نفسه، بل في الطموحات الصينية المتسارعة في القطب الشمالي. تعمل بكين على ترسيخ وجودها في المنطقة عبر بنية تحتية استراتيجية تشمل محطات أرضية للأقمار الصناعية وكابلات ألياف ضوئية، ضمن «طريق الحرير القطبي» و«طريق الحرير الرقمي»، وهو تمدد يحمل أبعاداً أمنية لا تحظى بالاهتمام الأوروبي الكافي.
في المقابل، بدأت دول في حلف شمال الأطلسي، من بينها فرنسا وألمانيا والسويد والنرويج وفنلندا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا، بإرسال قوات عسكرية إلى غرينلاند. ورغم أن الهدف المعلن هو ردع أي خطوة أمريكية محتملة، فإن هذا الانتشار يفرض واقعاً جديداً: التعامل الجدي مع أمن غرينلاند بعد سنوات من الإهمال الدنماركي والأطلسي.
من زاوية أخرى، يمكن القول إن صدام ترامب المباشر أدى دوراً محفزاً للأوروبيين، إذ أجبرهم على مواجهة تهاونهم إزاء التهديد الروسي، ودفعهم، بالقوة السياسية لا بالدبلوماسية الناعمة، إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وليس من قبيل المصادفة أن يصف الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، هذا التوجه بأنه “أكبر نجاح لترامب في السياسة الخارجية”.
صحيح أن أسلوب ترامب صدامي ومستفز، لكن اللافت أن أوروبا تجاهلت المطالب ذاتها عندما طُرحت سابقاً بلغة أكثر ليونة. المشكلة لم تكن في المضمون، بل في الطريقة.
اليوم، تبدو ردود الفعل الأوروبية عاطفية أكثر منها عقلانية، رغم أن نوايا ترامب، في جوهرها، لا تستهدف إضعاف أوروبا. فهو ينطلق من قناعة بضرورة إبعاد القوى الأجنبية عن نصف الكرة الغربي، وفق صيغة معاصرة لمبدأ مونرو، من دون منح روسيا نفوذاً في أوروبا أو الصين نفوذاً في آسيا، كما توضحه وثائق استراتيجيته الأمنية.
تضع هذه الاستراتيجية أوروبا في مرتبة متأخرة نسبياً بعد نصف الكرة الغربي ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويمكن الاختلاف مع هذا التصور، خصوصاً في ظل التحديات الصينية والروسية المتزامنة، غير أن ذلك لا يلغي حقيقة أن أوروبا ما تزال قادرة على التأثير في مصيرها إذا أحسنت قراءة موازين القوى.
في المحصلة، لن تؤدي سياسة استرضاء بكين أو موسكو إلى تعزيز أمن أوروبا. المطلوب هو قراءة واقعية لنوايا واشنطن والتعامل مع عالم تُستخدم فيه القوة الأمريكية أساساً لحماية المصالح الأمريكية، لكنها، بحكم الأمر الواقع، ما تزال تشكل أحد أعمدة الاستقرار والأمن للقارة الأوروبية نفسها.